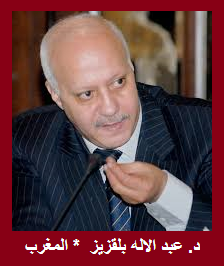ليستِ الدولةُ، وحدها، التي تضع الأسس الماديّة والمؤسَّسية للمواطَنَة، وإن كانت الجهةَ ذات الدور الأساس في إنجاز ذلك؛ وإنما يشاركها المجتمع، بمؤسّساته وعملها الوظيفيّ، في التمكين للبناء المواطنيّ، وفي التهيئة الاجتماعيّة التحتيّة له. على مركزيّتهِ، التي ليست موضع جدل، لا يكفي عملُ الدولة وحده؛ وهو إن أفلح في وضع المداميك والأساسات – دستورياً وقانونيّاً ومؤسّساتيّاً – لن يستطيع أن يقوم مقام فاعلين اجتماعيّين آخرين تهيّئهم مواقعُهم في النظام الاجتماعيّ لأن ينهضوا بأدوارٍ مستقلّة، نسبيّاً، لا تتدخّل فيها الدولة وبالتالي، لأن يقدّموا مساهمةً حاسمة في إنجاز عمليّة البناء المواطنيّ. والمستفاد من هذا أنّ المواطنة، بوصفها ثقافةً وقيمًا، لا تُكْتَسب لمجرّد أنّ قوانين الدولة وتشريعاتها تُقِرّ منظومة الحقوق، التي نُطلق عليها اسم حقوق المواطنة، وإنما تُكْتَسَب بالتكوين والتربية والتعليم، كما بالارتياض عليها في خضمّ علاقات العمل والتواصل وتبادُل القيم في الجسم الاجتماعيّ. ودون ثقافةٍ مواطنيّة يتشبّع فيها المرءُ بقيم المواطنة لا تكون مواطنة، أو هي إن كانت موضوعيّاً، أي على صعيد منظومة القوانين، لا تكون ذاتيّاً؛ أعني لا يحصل الوعيُ بها، ولا ينشأ الحافز الداخليّ للتمسّك بها والدفاع عنها، بل والعمل على تنميتها بالمزيد من الموارد.
ليس ما نقولُه عن الديمقراطيّة وإمكانها إلاّ عينَ ما نقوله عن المواطنة وإمكانها؛ فإذا صحَّتِ القاعدةُ التي تمسَّكنا، دائماً، بالانطلاق منها في رؤية مسائل الممكن والممتنِع في الديمقراطيّة، والتي مبناها على أنّه ما من ديمقراطيّةٍ تُمْكِن في مجتمع إلاّ متى تشبَّع مواطنو ذلك المجتمع بالقيم الديمقراطيّة، تَصِحُّ – بالتّلقاء- على المواطنة لتجانُسِ معناها والديمقراطيّة. وبيانُ ذلك أنّ المرء لن يملك أن يتمتّع بمواطنته، وما تُرتّبه عليه من حقوق وحرّيات، إن هو لم يَتَحَلّ بقيم المواطنة إن كان وعيُه، مثلاً، ما زال يدور في محيط أفكار سابقة للفكرة المواطنيّة.
استتبابُ أمر المواطنة، كاستتباب أمر الديمقراطيّة، وقْفٌ على إحرازِ نجاحٍ حقيقيّ في التربية عليها؛ في ازدراع قيمها في النفوس والأفعال؛ في ترسيخها كثقافةٍ عميقة؛ في تمنيعها من أيّ كابحٍ يفضي إلى تهشيشها…إلخ. وليس غير المجتمع ومؤسّساته يقْوى على أداء هذا الدور الإنمائيّ لفكرة المواطنيّة في الوعي الجمْعيّ. ولقد يكون عَمَل مؤسّستيْن اجتماعيّتيْن كبيراً، في هذا المضمار، هما الأسرة والمدرسة؛ فهما المصنع الاجتماعيّ الأوّل للتنشئة والتكوين، وعلى مثال ما تكُونَانِه يكونُ المجتمعُ الذي يتولّد من رحميْهما. على أنه لا النظام الأُسْري ولا النظام التعليميّ يملكان أن ينهضا بدورٍ إنمائيّ لقيم المواطنة من تلقاء النفس؛ إذ هُمَا، اليوم، من التهالُك والسلبيّة إلى الحدّ الذي يُخشى فيه على مستقبل المجتمع. لذلك لا مناص من أن يُعاد تأهيلُ المؤسَّسَتيْن تيْنك بالقيم عينِها التي يُعَوَّل على قيامهما بدور إشاعتها وترسيخها في نفوس الأجيال الجديدة وعقولها. والشيء عينُه يَصْدُق على مؤسّسات اجتماعيّة أخرى، يوكَل إليها أمْرُ البناء المواطنيّ؛ فهذه – هي الأخرى- ممّا يحتاج إلى إعادة تأهيل في أفق النهوض بدورٍ تاريخيّ بحجم بناء علاقات المواطنة وإنتاج ثقافتها وقيمها.
قلنا إنّ المؤسّسات الاجتماعيّة لا تملك أداء دور البناء المواطنيّ، بالتّلقاء، ومن دون إعادة تأهيلٍ من الداخل. ومعنى هذا أنّ استقامة فعلها على المقتضى المطلوب إنما هي مشروطة بما يمكن أن تقدّمه الدولةُ من مواردَ من أجل إعادة التأهيل، وترشيد الأداء. ولسنا نذهب، هنا، إلى القول إنّ على الدولة إعادة بناء الأسرة والأحزاب والمجتمع المدنيّ (علماً بأنّ ذلك إذْ لا يجوزُ، هنا، يجوز في حالة المدرسة والنظام التعليميّ)؛ إذ مع تسليمنا بحقيقة أنّ الدولة نهضت، دائماً، بدورٍ ثوريّ، تغييريّ، في المجتمعات فكانت بمثابة عربة القيادة التي تجرُّ قاطرتُها المجتمعات تلك نحو أهداف بعيدة، إلاّ أنّها لا تملك -حتى إن أرادت- أن تغيّر، جذريّاً، النظام الأُسْريّ والاجتماعيّ والحزبيّ – لأنّ تغيير هذه يكون من فعْلِ فاعلٍ أكبر هو التاريخ والتطوّر التاريخيّ والتراكم الاجتماعيّ والثقافيّ- ولكنّها تملك أن توفّر الأسس لتسهيل مثل ذلك التغيير في مَدَياتٍ من الزمن أقصر؛ بقوّة القانون والتشريع. إنّها، بهذه القوّة المشروعة التي تحتازُها، تملك أن ترشّد عمل تلك المؤسّسات، أو أن توجّهها وجهة خدمة الأهداف العليا (للدولة والمجتمع على السواء). وحين ينصرف النظام القانونيّ للدولة إلى بناء أساسات نظام المواطنة، يفرض إلزامه على مؤسّسات المجتمع كافّة، من وجهٍ عامّ، ويؤسّس لشرعيّة إحداث قوانين فرعيّة وقطاعيّة من شأنها النهوض بنظام الأسرة، والنظام المدنيّ والحزبيّ، وترشيد عملها في مضمار البناء المواطنيّ.
هكذا نتأدّى، إذن، إلى القول إنّ بناء نظام المواطنة مسؤوليّةٌ مشتركة للدولة والمجتمع على السواء.